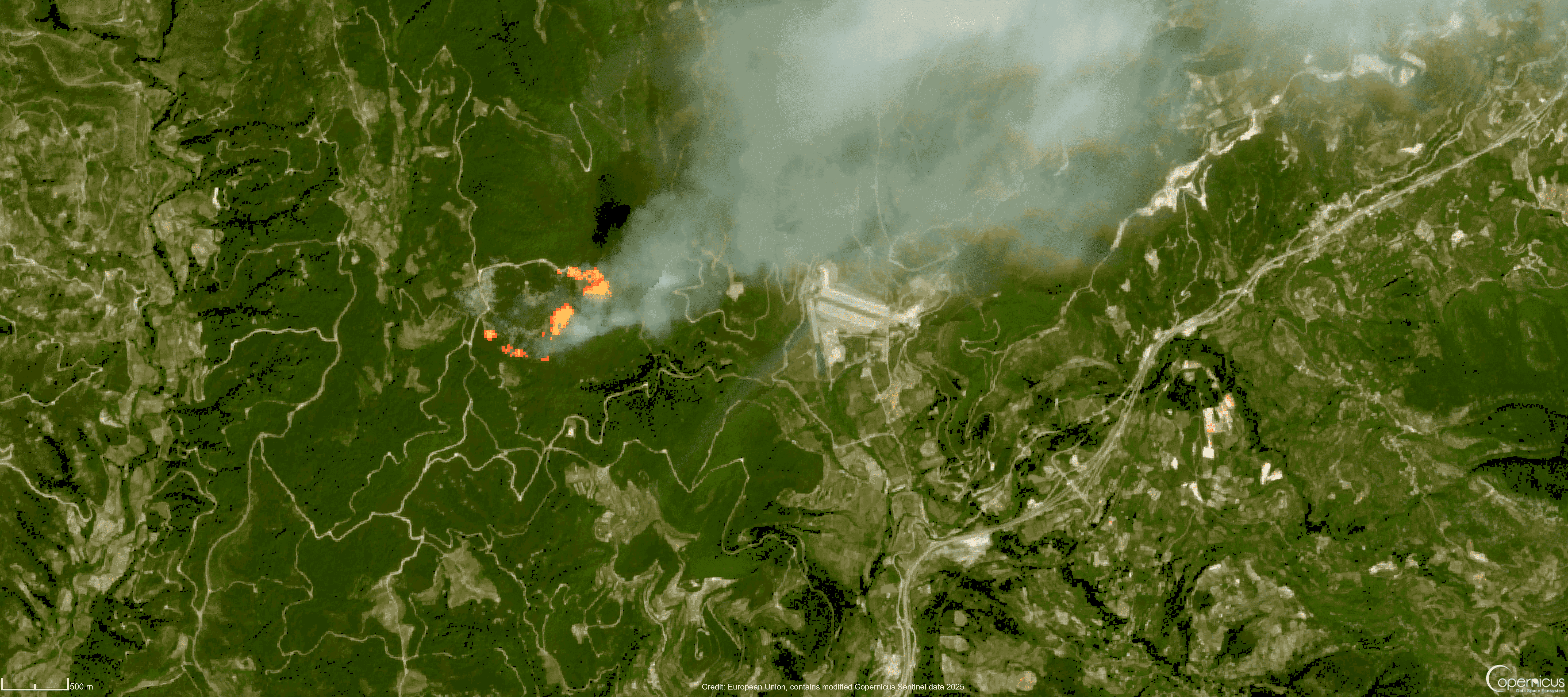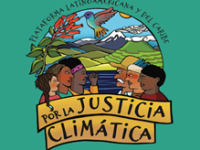يسلط هذا التقرير الضوء على تأثير التغيرات المناخية في انخفاض معدل هطول الأمطار بالأردن، وزيادة فترات الجفاف؛ ما أدى إلى تقليل كميات المياه الواردة للسدود، وجعلها عرضة لفقدان نصف سعتها التخزينية، ما ينعكس سلباً على ري المساحات الزراعية بالأردن.
يعاني المزارع رامي الفائز نقصاً في مياه الري التي تصل مزرعته الواقعة بالأزرق. يقول الفائز: “خلال العامين الماضيين تمّ تقليص عدد ساعات الري، بسبب نقص مخزون المياه الموجودة في سد الأزرق؛ ما يُسبّب لنا أزمة في الري”.
مشكلة الفائز يواجهها مزارعون آخرون، يعانون نقص مياه الري وعدم انتظامها، رغم وجود مزارعهم قرب السدود.
بدت آثار التغير المناخي واضحة خلال السنوات الأخيرة، وبشكل متزايد؛ خاصة على سعة تخزين السدود في الأردن.
تعتمد السدود في الأردن على مياه الأمطار، ولكنّ التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض معدل هطولها، وزيادة فترات الجفاف؛ ما أدى إلى تقليل كميات المياه الواردة للسدود.
نقص المياه وعدم وجود استراتيجية متكاملة للاستجابة للتغيرات المناخية، قادرة على التكيف مع هذه التحديات؛ جعل السدود عرضة لفقدان قدرتها على التخزين.
أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، الدكتور إلياس سلامة، يوضح تأثير التغير المناخي في السدود بالقول: “التغير المناخي ليس فقط زيادة أو انخفاضاً في معدل الأمطار أو الحرارة، وإنما زيادة سرعة جريان المياه التي تؤدي إلى زيادة انجراف التربة وكميات الرسوبيات الواصلة للسدود”.
ويضيف قائلاً: “سد الملك طلال مثلاً، غطّت الترسبات ما نسبته 20 في المئة من السعة التخزينية الإجمالية للسد، وهي نسبة مرتفعة”.
ويوجد بالأردن 17 سداً رئيسياً، تُستخدم هذه السدود في المقام الأول لتخزين المياه وتوفيرها للزراعة والاستهلاك المنزلي، إضافة إلى دورها في السيطرة على الفيضانات وإعادة تغذية المياه الجوفية.
لكن هذه السدود تأثرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغير المناخي، فلم تعد سعتها التخزينية الفعلية كما كانت سابقاً.
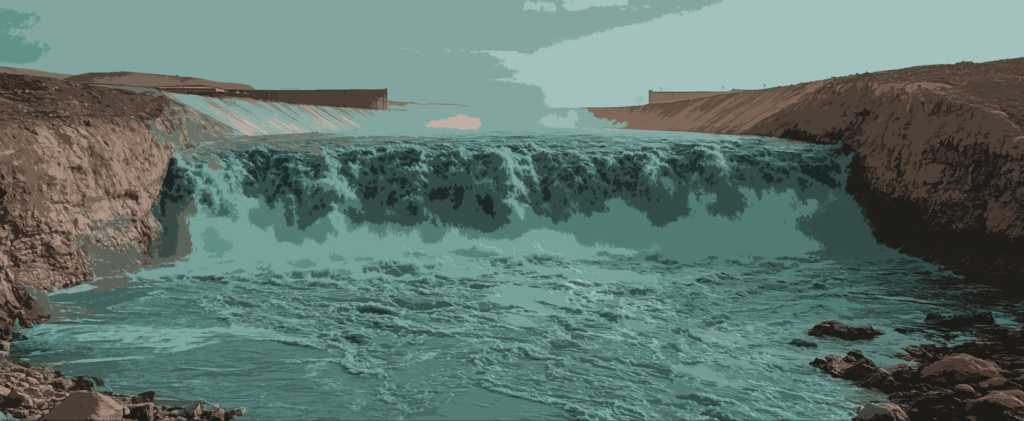
تؤدي عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة غزارة الأمطار خلال فترات قصيرة، إلى انجراف كبير للتربة وزيادة سرعة جريان المياه؛ ما يتسبّب في تراكم الرواسب والطمي داخل السدود، وبالتالي تستهلك حيزاً من مساحات تخزين المياه.
الحل الأسرع الذي اعتمدته وزارة المياه في الأردن، كان بناء سدود صغيرة لحجز الترسبات. لكن بحسب دكتور سلامة، فإن المسؤولية يجب أن تتشاركها وزارات المياه والري، والبيئة، والبلديات والأشغال؛ والأمانة، وهو ما يفرض على المملكة تحركاً موازياً، تتعاون فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع هذه التغييرات المتسارعة.
هذه الأزمة يؤكدها أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، مشيراً إلى أن المملكة متأثرة بالتغييرات المناخية وليست مؤثرة، برغم أنّ آثارها في الأردن أدت إلى خلق ظواهر طبيعية لم تكن موجودة سابقاً.
لكن هل يعني هذا أن تقف السلطات عاجزة؟
“بالطبع لا”، يضيف الحيصة: “في الأردن ما زالت السدود مع سعتها التصميمية وعمرها الزمني ضمن الحدود العالمية، لكنّنا لا نريدها أن تزيد”.
أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، الدكتور إلياس سلامة، يقول إن جميع مناطق روافد السدود تواجه مشكلة الترسبات داخل السدود، رغم وجود إجراءات للحد منها.
أشكال خطرة من التغير المناخي
ضاعفت التغيرات المناخية من تهديدها للسدود، وشكلت خطراً على استقرار الإنسان، إضافة إلى كونها تهديداً للبيئة.
وبحسب مدير مديرية البيئة والتغير المناخي في المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور جعفر وديان، فإن الدراسات المحلية في الأردن لا تسير بشكل متوازٍ مع هذه المتغيرات، ومنها ما تتعرض له السدود.
يضيف قائلاً: “نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات لإيجاد الحلول والتوصيات بهذا الصدد”.
ماذا على الأردن أن يفعل؟
يقول أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، إن وزارة المياه والري بدأت فعلياً بتنفيذ بعض المشروعات لتقليل التبخر من السدود، وأيضاً دراسة الأحواض المُغذِّية لسد الملك طلال؛ لإيجاد حلول مناسبة تُقلّل من تعرية التربة، من خلال زراعة الأشجار وإقامة بعض المصدّات على الأودية الرئيسية.
ويضيف بأن وزارة المياه تجري دراسة حول الأحواض المغذية لسد الملك طلال؛ لمواجهة مشكلة تعرية التربة وأثر الترسبات في السدود، مبيناً أن النتائج الأولية لهذه الدراسة أظهرت، حتى هذه اللحظة، حدوث زيادة في تعرية التربة نجمت عن التغير المناخي، وتغير البيئة المناسبة للنباتات الأصيلة.
وكانت وزارة المياه أطلقت استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023-2040، واستراتيجية سلطة وادي الأردن 2024-2026، اللتين تهدفان إلى إيجاد خطة تنفيذية تسهم في تعزيز الأمن المائي، وتزويد المزارعين في وادي الأردن بالمياه الكافية لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المصادر الحالية، وتخفيض فاقد المياه ورفع كفاءة القطاع، وتحسين إدارة المخاطر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
نوع مدمّر: حوض عمّان الزرقاء
صنّفت دراسات سابقة وجود انجراف وتعرية للتربة من النوع المدمر، على مساحة تمتد إلى 95 كيلومتراً مربعاً من منطقة حوض عمّان الزرقاء.
الدراسات هدفت إلى تقييم مخاطر انجراف التربة، وأوضحت أن إجمالي 350 كيلومتراً مربعاً يتعرض إلى انجراف شديد الخطورة، ويؤثر في الحوض بدرجة كبيرة.
ودعت الدراسات إلى ضرورة اتخاذ تدابير مباشرة، مثل دعم الغطاء النّباتي، وإدارة المنحدرات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء نظام مراقبة لمكافحة انجراف التربة.
وهذه ليست الدراسة التحذيرية الوحيدة، فقد كشفت دراسة للبنك الدولي ما هو أخطر.
أما دراسة انجراف التربة (وهي دراسة أعدتها وزارة المياه الأردنية) في حوض وادي الحسا الأوسط/ الطفيلة، فقد قايست كميـات تنـاثر التربـة، وكميـات التربـة المنقولـة بواسـطة الجريان السطحي؛ وكشفت بأن كمية التربة المتناثرة بالتطاير بلغـت 0.53 طن/دونـم في السنة.
وتُعزى أسباب ذلك؛ لارتفاع معدلات درجات الانحدار، وهشاشة التربة، وكثرة الانزلاقات الأرضية.
أما مدير مديرية البيئة والتغير المناخي، الدكتور جعفر وديان، فيستشهد بأكبر حوض في الأردن، حوض الأزرق؛ إذ تتجمع فيه مياه الأمطار في المنطقة الشرقية، ويصب فيه أكثر من 15 وادياً.
يضيف وديان: “عند تساقط الأمطار تتجمع في نقطة واحدة تُعرف بالحوض، حيث إن السدود تقام داخل الأحواض”.
ويشير إلى عدم وجود تقنيات حصاد مائي كافية لحفظ التربة؛ وهذه التقنيات يتمّ تنفيذها من خلال عمل جدران استنادية، تعمل على زيادة قدرة التربة في امتصاص الماء، ومقاومة الانجراف، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأحواض المائية، عن طريق زراعة الغابات ورفع نسبة الغطاء النباتي في الأراضي.
أما عن حوض وادي زغلاب، المُغذِّي لسد وادي زغلاب بلواء الكورة في محافظة إربد، فإن كمية الترسبات المتراكمة في الخزان تصل إلى 1.62 مليون متر مكعب، كما وجدت أن معدل تقلص السعة التخزينية للسد يبلغ 46 ألف متر مكعب في السنة، بحسب ما ورد في دراسة أجريت عام 2002.
دكتور وديان يعلق على وضع السد الحالي قائلاً: “سعته التخزينية أصبحت لا تتجاوز النصف أو أقل، ما يستوجب معالجة التدهور الحاصل، فالتربة قيمتها كالوقت، تذهب ولا تعود”.
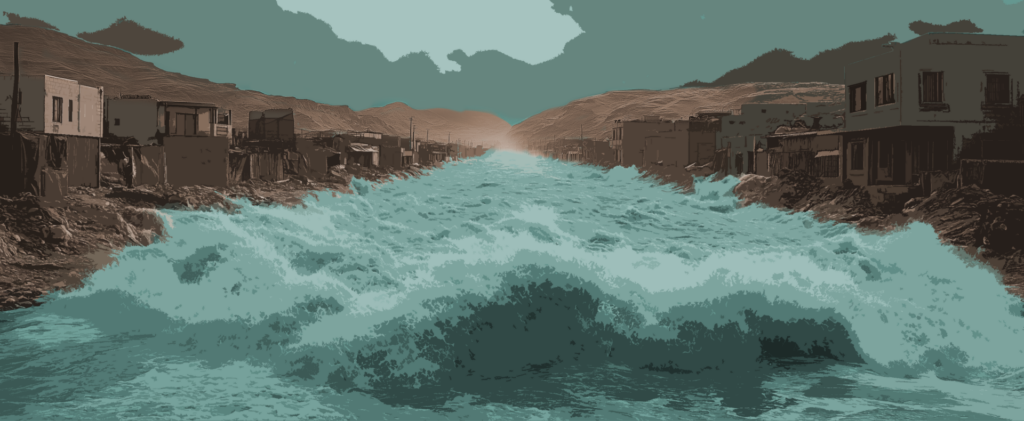
تقول وفاء أبو حمور، باحثة في التغير المناخي، إن الفيضانات الوميضية كان لها آثار سلبية في التربة والمياه والقطاع الزراعي، فقد أدت إلى انجراف التربة وتدمير البنية التحتية وزيادة الترسبات في السدود.
لا تحتاج الفيضانات الوميضية إلى مقدمات لحدوثها. وهي تؤثر في المناطق المنحدرة ما يؤدي إلى انجراف التربة نتيجة غياب الغطاء النباتي، وسرعة مياه تلك الأمطار وكثافتها، واستقرارها في أماكن منخفضة، حيث تشكل السدود جزءاً منها.
لهذا، تطالب أبو حمور بتطوير خطط لمكافحة آثار الفيضانات الوميضية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، مبينة أن الأردن بحاجة إلى تكثيف الجهود لتقليل المخاطر عبر تحسين الأساليب والأدوات الموجودة حالياً.
كما تطالب بدراسة وتحليل العوامل التي تزيد من الفيضانات الوميضية، وفهم العلاقة بين التغير المناخي وبوار الأراضي الزراعية.
وإذا كانت قضية المياه والسدود تُعدّ قضية ملحة في كل دول العالم، فإنها في الأردن مسألة حياة أو موت، لما يعانيه الأردن من فقر مائي دائم ومتزايد، يؤثر في التربة والزراعة واستقرار وحياة المواطن الأردني.
أنجز هذا التقرير بدعم من أريج